مش غريب نقول إن الشيطان بيستخدم كل وسيلة يقدر عليها علشان يشكك في
مصداقية وكلام ربنا. هو بدأ الهجوم ده من أول جنة عدن مع حواء ولسه مكمل لحد
دلوقتي. بس غالبًا طريقته بتكون أذكى من الكذبة الواضحة اللي حواء صدقتها. إحنا
عايشين في زمن متطور، حتى في الدراسات الكتابية والنقد النصي، بقينا نسمع عن
استخدام الكمبيوتر وأدوات تقنية معقدة. والشيطان مش عنده مانع يواكب التطور ده،
خصوصًا لما الأدوات دي بتخلي بعض الناس يقولوا إن نصوص العهد الجديد الأصلية فيها
أخطاء، بناءً على قواعد وممارسات نقد النص اللي بقت منتشرة ومقبولة.
الفترة من سنة 1830 لـ 1880 كانت مرحلة جمع معلومات وتجميع مخطوطات أكتر
للعهد الجديد، وكمان اقتراح ونقاش نظريات جديدة عن النصوص. في الوقت ده، كان فيه
علماء زي غريسباخ، لاخمان، تريجيليس وتيشندورف مسيطرين على المجال. لكن سنة 1880،
ويستكوت وهورت قدموا نظرية جديدة عن النصوص، ومع شوية تعديلات بسيطة، المجتمع
الأكاديمي تبناها، وبقت هي المرجع الأساسي في المجال لأكتر من قرن.
ببساطة، نظرية ويستكوت وهورت بتفرّق بين عائلات مختلفة من المخطوطات، زي
النص الإسكندري، الغربي، البيزنطي، والقيصري. النظرية بتقول إن النص الإسكندري
يعتبر من النصوص القديمة، لكن النص البيزنطي ظهر تقريبًا في أول ربع من القرن
الرابع الميلادي. كمان النظرية بتدي أهمية كبيرة لأقدم مخطوطتين بالنص الكبير (uncial)، اللي هما ألف (سينائيكوس) وبي
(فاتيكانوس)، واللي بيرجعوا لنص القرن الرابع. الاتنين دول اتسموا بـ "النص
المحايد"، رغم إن التسمية دي فيها جدل.
باختصار، المبادئ الجديدة اللي ظهرت في نقد نصوص الكتاب المقدس قلبت
الطريقة القديمة رأسًا على عقب. لما اعتبروا إن النص البيزنطي (اللي هو الأغلب في
المخطوطات) نص متأخر، بدأوا يستبدلوه بالنص اللي بيسموه "محايد" أو
"نقي"، واللي بيقولوا إنه أقدم وأدق.
معظم التغييرات دي ما كانتش بتأثر على المعنى بشكل كبير، غالبًا كانت
اختلافات بسيطة في ترتيب الكلمات أو في الإملاء. لكن في حالات كتير – وأحيانًا
لأسباب منطقية – اتشالت كلمات أو جمل أو حتى آيات كاملة من النص اللي الناس كانت
معتادة عليه.
ولو فتحت ترجمات حديثة زي RSV أو NASB أو NEB أو NIV، وبصيت في الهوامش، هتلاقي أمثلة كتير على
التغييرات دي، وده يوضح قد إيه المبادئ دي اتطبقت بشكل واسع في عصرنا.
في كلامه عن نظرية ويستكوت وهورت، جورج لاد[1]
كتب إننا "وصلنا للنص المتفق عليه." [2]
وبيرجع يؤكد إن: "من النادر حد يعارض فكرة إن النقد النصيّ قدر فعليًا يسترجع
النص الأصلي للعهد الجديد."[3]
وهو شايف إن "في البحث عن نص جيد، الورع والتقوى ما ينفعوش يكونوا بديل عن
المعرفة والحُكم العلمي."[4]
إيفرت ف. هاريسون بيلاحظ إن فيه اتجاه لإعادة تقييم النص البيزنطي، لأن بعض
البرديات القديمة بتوضح إن فيه قراءات معينة من النص الأغلب (البيزنطي) بتكون أقدم
من القراءات اللي في النص المحايد. وده خلّى العلماء يستخدموا طريقة اسمها
"الانتقائية" eclectic
methodology، يعني بيحاولوا يوزنوا كل
العوامل اللي في الصورة.[5]
بس هو بيأكد إن ده معناه إن قراءات النص البيزنطي لازم تتاخد في الاعتبار،
مش تتترمي على طول. كمان بيقول إن في الطريقة دي، الأدلة الخارجية غالبًا بتتاخد
كأنها أقل أهمية، وده شيء مؤسف.
ج. هارولد جرينلي بيضيف إن تجاهل الأدلة الخارجية والاعتماد الكامل على
الأدلة الداخلية ممكن يخلي القرارات تبقى شخصية زيادة عن اللزوم. وعلشان كده لازم
يكون فيه توازن بين الأدلة الداخلية والخارجية.[6]
ويستكوت وهورت طوروا طريقة فيها نوع من التفكير الدائري، واللي خلتهم
يتجاهلوا بشكل عملي النظر المنطقي في الكمية الكبيرة من المخطوطات اللي بتشكل
الأدلة الخارجية. هم كانوا شايفين إن أفضل الأدلة الخارجية موجودة في المخطوطات
اللي فيها "أفضل القراءات". وطبعًا "أفضل القراءات" دي كانت
في النص اللي هم سموه "النص المحايد".
علشان يحددوا إيه هي القراءات المفضلة، استخدموا فكرتين:
(1) الاحتمال الداخلي، وده بيحاول يحدد أي قراءة من القراءات المختلفة بيعبر عن أسلوب الكاتب نفسه.
(2) الاحتمال النسخي، وده بيحاول يعرف أي قراءة ممكن تكون ظهرت بسبب النُسّاخ.
القانون الأول، زي ما ممكن تتخيل، اتعرض لسوء استخدام وتكهنات حتى من
العلماء المتقنين والمتدينين، لأنه بيعتمد على تقييم شخصي. أما القانون التاني،
فبياخد في اعتباره التغييرات اللي النُسّاخ ممكن يكونوا عملوها سواء عن قصد أو من
غير قصد.
النُسّاخ كانوا ساعات بيضيفوا حاجات في النص زي التوضيح أو التفسير أو
تكرار بالخطأ أو دمج بين قراءتين مختلفتين. وفي نفس الوقت، ساعات كانوا بيشيلوا
حاجات من النص بسبب أخطاء زي إنهم يكتبوا الكلمة مرة واحدة بدل مرتين (haplography)، أو يخلطوا بين سطور نهايتها شبه بعض (homoioteleuton)، أو حتى بسبب تعديل متعمد. وكمان ممكن تكون
فيه تغييرات حصلت بسبب خلافات لاهوتية أو تدخل من ناس كانوا ضد الكنيسة أو من
الهراطقة.
القواعد الأساسية اللي بيستخدموها علشان يقرروا في حالات الأدلة الداخلية
ممكن تتلخص في الآتي:
(1) يفضلوا القراءة اللي تفسّر ظهور باقي الاختلافات،
(2) يفضلوا القراءة الأقصر،
(3) يفضلوا القراءة الأصعب،
(4) يفضلوا القراءة اللي شكلها أكتر بتعبر عن أسلوب الكاتب.
وطبعًا كل قاعدة من دول بتتطبق بشكل شخصي إلى حد كبير. ولما القرار بيكون
صعب في موضوع الأدلة الداخلية، العلماء ساعات بيرجعوا لطريقة التفكير الدائري
القديمة اللي بتقول: "في مخطوطات معينة بتدعم النص الأصلي أكتر من غيرها،
والمخطوطات دي هي الإسكندرانية القديمة. فلو الأدلة الداخلية مش قادرة تحسم،
جوردون فيي بينصح إن أفضل حل هو الاعتماد على أفضل المخطوطات."[7]
وبالتالي، الأدلة الخارجية بتكون آخر حاجة يلجأوا ليها، ولما بيستخدموها،
بيكون القرار أصلاً متأثر بفكرة مسبقة عن إيه هي المخطوطات الأفضل.
[1] چيمس بورلاند أستاذ في
اللاهوت ودراسات الكتاب المقدس في كلية ليبرتي المعمدانية في لينشبرج، فيرجينيا.
JETS 25:4 (December 1982) p. 500
[2] G. E. Ladd, The New Testament and
Criticism (Grand Rapids: Eerdmans, 1967) 77.
لكن ج. د. فيي بيقول إن طريقة هورت
الجينية
(genealogical method) تم رفضها، وده أدى لظهور طريقة جديدة
اسمها modern
eclectic method،
واللي اتكلم عنها في:
“The Textual Criticism of the
New Testament,” Expositor’s Bible Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1979),
I. 419–433; “Rigorous or Reasoned Eclecticism—Which?”, Studies in New Testament
Language and Text (ed. J. K. Elliott; Leiden: Brill, 1976) 174-197.
[3] Ladd, New Testament and Criticism 80.
فيي بيقول بنفس الجرأة إن "مهمة نقد نصوص العهد الجديد تقريبًا
خلصت"؛ في مقاله :
Modern Textual Criticism and the Revival of the Textus
Receptus".JETS 21 (1978) 19-33. But note I. A. Moir’s word of caution
regarding the UBS text; “Can We Risk Another ‘Textus Receptus’?”JBL 100 (1981)
614-618.
[4] Ladd, New Testament and Criticism 81.
[5] E. F. Harrison, Introduction to the
New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1971) 82.
[6] J. H. Greenlee, Introduction to New
Testament Textual Criticism (Grand Rapids: Eerdmans, 1964) 119.
[7] Fee, “Textual Criticism of the New
Testament” 431.
[8] G. Salmon, Some Thoughts on the
Textual Criticism of the New Testament (London: John Murray, 1897) 26
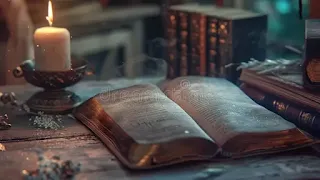

.webp)