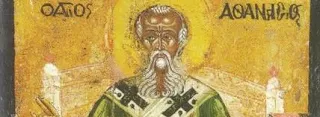هدف الدفاعيات هو
التفاعل مع ثقافاتنا المُعاصرة، بدلاً من الهروب منها، أنها تهدف إلى تحويل المؤمنين
إلى مُفكرين، والمُفكرين إلى مؤمنين. الدفاعيات تحترم ما تتميز به الكرازة
المسيحية من فكر صلب وخيال ثري وعمق روحي، وتعلنه بطرق قادرة على الإندماج في
ثقافتنا.[1]
لا يجب
النظر إلى الدفاعيات باعتبارها رد فعل دفاعيًا عدائيًا تجاه العالم. فعلى العكس
تمامًا، الدفاعيات هي محاولة جعل الإيمان المسيحي مقرؤًا ومفهومًا أمام العالم، هي
حركة إزالة الحواجز التي تعوق العقل من تقّبل الإيمان المسيحي.
عادة ما
يُساء فهم المؤمنين على أنهم مجموعة من الجهلة البسطاء الذي يعتقدون في الخرافة
والمجهول، يأتي هُنا دور الدفاعيات في إزالة تلك المفاهيم الخاطئة عن المؤمنين،
فالمسيحي مُطالب أن يتفهم إيمانه ويتعقله ويستخدم ذهنه ويطّلع على الكتابات عامة
لا الدينية منها فقط، المسيحي على اعتناق ما يتنافى مع العقل والمنطق –وإن كان
يُمكنه أن يؤمن بما يفوق العقل وليس ما يخالفه- فالإيمان المسيحي قابل للشرح
والتوصيف بأدلة من المنطق والفلسفة وليس بعيدًا عنها.
وعليه،
فالمؤمن يتحرك بدافع قلبي، أو لنقل بدافع حب تجاه الآخر وتجاه العالم، ليس معارضًا
للآخر، بل موجهًا مُرشدًا محاولاً توضيح الأمور كما هي عليه، أو إزالة الأفكار
الخاطئة عن ما يعتقده الآخر في الإيمان، وهو ليس منه.
الدفاعيات
هي دفاع عن الحق بلطف واحترام، الدفاعيات لا تهدف إلى استعداء من هم خارج الكنيسة
ولا إهانتهم، بل إلى فتح عيونهم على واقعية الإيمان المسيحي، وصدقه، وملاءمته
لحياتهم واحتياجاتهم. لا يجب أن يحدث تعارض أو تناقض بين الرسالة المُعلنة ونبرة
اللاهوتي الذي يعلنها، فلابد أن نكون جذّابين، لطفاء، كريمي الخُلق. [2]
فغالبًا ما
تتعرض المعتقدات المسيحية إما لسوء فهم أو سوء تفسير. وهذا ما جعل الدفاعيات
المسيحية أمرًا ذو ضرورة مُلحة منذ فجر المسيحية وحتى اليوم.[3]
يجب أن
نفهم الدفاعيات على أنها ترس في آلة الإيمان الكبيرة، لا يمكن اعتبار هذا الترس
وحده هو ما نستطيع من خلاله أن نخلص، ومن الصعب أيضًا أن نعتقد أنه غير ذي أهمية.
فللدفاعيات مُهمة مُحددة وهي نشر الوعي برسوخ وعظمة الإيمان المسيحي، عملها هو
إزالة العوائق التي تحجب نور الله عن البشرية. فالخلاص لا يتم بالدفاعيات، بل
بالحقيقة العظمى المُختصة بالله والمسيح، تلك التي إحدى طرق الوصول إليها هي
الدفاعيات.
يمكن تشبيه الدفاعيات بإزاحة الستار حتى يتمكن الناس من رؤية لمحة لما يختبئ وراءها، أو برفع
ماسة مقابل النور فتتلألأ وجوهها وتبرق عند سقوط أشعة الشمس عليها. فالدفاعيات
تهتم بتأسيس مداخل للإيمان، سواءً تخيلنا هذه المداخل فتح أبواب، أو إزاحة ستار،
أو إضاءة مصباح حتى يرى الناس بمزيد من الوضوح، أو استخدام عدسة تضع الأشياء في
البؤرة. والموضوعات الرئيسية في الدفاعيات هي تلك التي تتيح للناس رؤية الأشياء بوضوح، وربما للمرة الأولى،
تساعدهم على اكتشاف الأفكار المُضللة، فيدركون فجأة سرّ ما يتمتع به الإيمان
المسيحي من قدرة على الإقناع على المستوى الفكري وجاذبية على المستوى التخيلي.
فالدفاعيات تقوم بمد الجسور التي يعبر عليها الناس من العالم الذي
يعرفونه إلى العالم الذي يودون اكتشافه، وتساعدهم في العثور على أبواب ربما لم
يسمعوا بها من قبل، فيرَون عالماً يفوقُ كل تخيلاتهم ويدخلون فيه. والدفاعيات تفتح
العيون وتفتح الأبواب بتأسيس مداخل للإيمان المسيحي.[4]
تُعتبر صورة الشمس والنافذة من أهم الصور التي
استخدمها اللاهوتيون في العصور الوسطى لشرح ما تجريه نعمة الله من تغيير في النفس البشرية. وتُعَد كتابات "ألن الذي من لِيل"Alan of Lille مثالاً جيدًا على هذا حيث يشَبه النفس البشرية
بحجرة باردة مظلمة. ولكن عندما تُفتح النافذة على مصراعيها، يندفع نور الشمس إلى
الحجرة فيشيع فيها النور والدفء. إلا أن فتح النافذة لا يدفئ الغرفة ولا ينيرها،
ولكنه يزيل حاجزًا من أمام القوة التي يمكنها أن تفعل ذلك، فسبب التغيير الحقيقي
هو الشمس. وكل ما نفعله نحن أننا نزيل الحاجز الذي يمنع نور الشمس وحرارتها من
دخول الحجرة.
وهذه الصورة تساعدنا على إدراك هذه الفكرة
اللاهوتية، وهي أننا لا نتسبب في تغيير الناس وقبولهم للإيمان. ويؤكد “ألن” أننا
نحن الذين لا بد أن نفتح نافذة عقولنا على مصراعيها، فتتمكن نعمة الله من العمل في
حياتنا، وهكذا ينحصر دورنا في إزالة العوائق من أمام نعمة الله، أما تجديد نفوسنا
فهو مهمة هذه النعمة الإلهية. إلا أن الصورة مهمة في مجال الدفاعيات أيضًا، فهي
تُذكرنا أن الله هو من يغير النفوس، وتؤكد في الوقت نفسه أننا قادرون على تيسير
هذه العملية بالمساهمة في إزالة الحواجز والعوائق التي تقف أمام نعمة الله.[5]
فأفضل دفاع عن المسيحية هو شرحها. أي أنك إن أردت أن تدافع عن
المسيحية أو تبرز جمالها، فأفضل السبل لذلك أن تبدأ بتعريف الناس بماهية المسيحية،
لأن الكثيرين لديهم مفاهيم خاطئة عن المسيحية تعيق قبولهم للإيمان. ومن أروع
الأمثلة على ذلك مثال يقدمه اللاهوتي العظيم القديس أغسطينوس الذي قبِل الإيمان
بعد جولة طويلة في أراضي الفلسفة المجدبة.[6] كان أغسطينوس شابًا موهوبًا
في الخطابة[7] من شمال أفريقيا، وقد صاحب
المانويين، وهي طائفة كانت شديدة الانتقاد للمسيحية، هكذا استقى جُل معرفته
بالمسيحية من نُقادها، لم تكن بالمعرفة الدقيقة. ورفض أغسطينوس المسيحية باعتبارها
لا تستحق اهتمام شخص في ثقافته وذكائه.
وكان أغسطينوس طموحًا، فقرر أن يكون رجلاً
ناجحًا في عاصمة الإمبراطورية، فغادر شمال أفريقيا متجهًا إلى روما. وبعد فترة
وجيزة من وصوله، عُرِضَت عليه وظيفة خطيب عام في ميلانو، وهي المدينة الرئيسية في
شمال إيطاليا. ونظرًا لإدراكه بأن هذه الوظيفة يمكن أن تمثل بداية لحياة مهنية ذات
شأن في العمل المدني بالإمبراطورية، رحب أغسطينوس بالعرض. إلا أنه كان يعلم أيضًا
أن تقدمه في المجال السياسي يعتمد على قدراته البلاغية. فمن يستطيع أن يساعده في
تطوير هذه المهارات؟
اكتشف أغسطينوس بعد وصوله إلى ميلانو أن أمبروسيوس
Ambrose أسقف المدينة المسيحي مشهور ببراعته في الخطابة، فقرر أن يكتشف بنفسه
ما إذا كان يستحق هذه الشهرة. فكان كل يوم أحد يتسلل إلى الكاتدرائية الكبيرة في
المدينة ويستمع لعظات الأسقف. وفي البداية لم يكن اهتمامه بالعظات سوى اهتمام
الشخص المتخصص الذي ينظر للعظة باعتبارها خطبة فخمة. ولكن محتوى العظات بداً
يستحوذ عليه تدريجيًا. فنجده يكتب:
"اعتدت
أن أسمع عظاته متحمسًا، ولكني لم أكن مدفوعاً لذلك بالدافع الصحيح، بل كنتُ أريد
أن أختبر مهارته في الخطابة لأرى ما إذا كانت طلاقته أفضل مما قيل لي عنه أم أدنى…
ولكني لم أكن مهتمًا بما يقول، وكانت أذناي لا تتجه سوى نحو أسلوبه في الخطابة…
إلا أنه كما دخلت الكلمات التي أمتعتني إلى عقلي، هكذا دخلت المادة التي لم أكن
أعبأ بها في بادئ الأمر، حتى إني لم أتمكن من الفصل بينهما. فبينما كنت أفتح قلبي
لفصاحته، دخل معها أيضًا الحق الذي كان يعلنه".[8]
وكما يتضح من رحلة أغسطينوس الطويلة إلى
الإيمان، نجح أمبروسيوس (الذي أصبح أغسطينوس يعتبره واحدًا من أبطال اللاهوت) في
إزالة عائق ضخم من طريق الإيمان. فقد أبطل مفعول الصورة المغلوطة التي روّجتها
المانوية عن المسيحية. وبعد أن استمع أغسطينوس لأمبروسيوس بدأ يدرك أن المسيحية
أكثر جاذبية وإقناعًا مما كان يظن بكثير. وهكذا أزيل عائق يقف أمام الإيمان.
وبالرغم من أن أغسطينوس لم يؤمن بالمسيحية إلا بعد فترة، فقد كان لقاؤه مع أمبروز
علامة بارزة على طريق البحث.[9]
فالدفاعيات المسيحية تعني بتوصيل فرح الإيمان
المسيحي واتساقه وملاءمته للحياة من ناحية، وبالتعامل مع ما يواجهه الناس من شكوك
ومخاوف وتساؤلات حول الإيمان من ناحية أخرى. وهذا ما نراه منذ زمن العهد
الجديد حتى الآن.[10] والدفاعيات تؤكد وجود
إجابات أمينة ومقنعة للأسئلة المخلصة التي يسألها الناس عن الإيمان. وهذه الأسئلة
لابد أن تُحترم وتؤخذ على محمل الجد. والأهم من هذا، أنه يجب الإجابة عليها.
والأهم من هذا وذاك أن الإجابات موجودة.
وتختلف الأسئلة التي تثار حول الإيمان من ثقافة إلى أخرى. فالكُتّاب
المسيحيون الأوائل، على سبيل المثال، انشغلوا بكيفية مواجهة نقد الفلسفة
الأفلاطونية لمعتقداتهم من ناحية، وبكيفية تصميم أسّاليب فعّالة لتوصيل إيمانهم
وإبراز جماله للأفلاطونيين من ناحية أخرى. في حين أنه في بداية العصور الوسطى ركز
الكثير من اللاهوتيين في أوروبا الغربية، ومن بينهم الفيلسوف العظيم توما
الأكويني، على الأسئلة الدفاعية التي أثارها الكُتَّاب المسلمون.[11]
فالنقطة المهمة هُنا أن تفهم مستمعيك وتتعرف على
شكوكهم وأسئلتهم. ولا يجب أن تنظر إلى هذه الأسئلة باعتبارها تهديدات مكروهة، بل
رحِّب بها على اعتبار أنها يمكن أن تمثل مداخل للإيمان. فالسؤال يعني أن صاحبه
مهتم وراغب في الاستماع. وقد يكون هدف السائل أن يسدد لك الضربة القاضية بسؤاله،
ولكن حتى لو كان الأمر كذلك، فالسؤال يتيح لك فرصة ذهبية لتوصيل الإنجيل عليك أن تُقّدرها
وتنتهزها، لأن هذا النوع من الأسئلة يمنحك الفرصة لتزيل الغموض عن بعض ألغاز
الحياة العويصة، ومن هذه النقطة يمكنك أن تشرح الرؤية المسيحية للواقع وتبرز
حُسنها. ففي دفاعك عن المسيحية، لا داعي لتكوين توجه دفاعي، وكأنك تدافع عن عقيدتك
ضد هجوم يُشن ضدها. ولكن عليك أن تنظر لكل سؤال على أنه فرصة لإزالة سوء الفهم،
وإظهار مصداقية الإيمان وجاذبيته، والحديث عن تأثيره على الحياة. ومن ثم، لابد من
الترحيب بالأسئلة ولابد من تكوين إجابات جيدة وتقديمها للسائل. والإجابات متوفرة
بالفعل، وليس علينا سوى أن نكتشفها ونطّوعها بما يتناسب مع مهاراتنا في الحديث ومع
الجمهور الذي نتفاعل معه.
فالدفاعيات ليست مُشاجرة ولا عراكًا ثنائيًا،
بين من هم في ضلال مُطلق ومن يمتلكون الحق المُطلق. فالدفاعيات ليست حرب بل هي
مُحاججة، نُقدم من خلالها البراهين المنطقية والأخلاقية والتاريخية على حقيقة ما
نؤمن به. وبينما نقوم بأداء هذه المُحاججة، فإننا نضع في أعمق أعماق أذهننا أننا
لسنا "مُلاَّك الحقيقة المُطلقة"، فلا يُمكن تخيل مدى الفساد الذي ينحدر
بمن يظنون أن لديهم تفويضًا إلهيًا. نحن نثق في إيماننا، لكن هذا لا يعني أن
أفكارنا البشرية، وتفسيراتنا لهذا الإيمان، دائمًا صحيحة ودائمًا على صواب، فربما
هُناك تفسيرات أُخرى لذات الإيمان، ولكنها تعالجه بشكل أفضل كثيرًا من قناعتنا
الحالية.
[1] أليستر
ماجراث، الدفاعيات المُجردة، ص 13.
[2] الدفاعيات
المُجردة، 18.
[3] كما سنرى
في الفصول القادمة المختصة بتاريخ علم اللاهوت الدفاعي.
[4] الدفاعيات المجردة، 127.
[5] المرجع
السابق، 127، 128.
[6] Peter Brown, Augustine
of Hippo (London: Faber & Faber, 1967).
[7] الخطابة:
هي فن الإقناع وقد ظهرت في بدايات القرن الخامس قبل الميلاد في الكتاب الثاني من
الإلياذة، والذي يتحدث عن الحملة الإغريقية المُتجهة نحو طروادة، فمصيرها كان
يعتمد على قدرة الخطباء على إقناع الجنود بالبقاء في صفوف الحرب وحضهم على القتال
بشجاعة. وقد استحدثت الحياة الديموقراطية في أثينا نوعين من الخطابة، وهما: 1-
ويقوم بها رجل فصيح يُمثل الدولة بإقناع أعضاء المجلس على التصويتا لأجل مقترحاته.
2- الخطابة القضائية، وقد أسسها شخص يُدعى كوراكوس، وهي أشبه بما يفعله المحامون
اليوم من دفاع أمام المحاكم العامة، وكانت تتكون من (مقدمة- موضوع- برهان- خاتمة).
أحمد عتمان، الأدب الإغريقي تراثًا إنسانيًا وعالميًا، ص 497: 500.
[8] Augustine, Confessions V.xiii.23-xiv.25.
[9] الدفاعيات المجردة، 130 ، 131.
[10] For apologetic motifs in the
New Testament, see Avery Dulles, A History of Apologetics (San
Francisco: Ignatius Press, 2005), 1-25.
[11] الدفاعيات المجردة، 157.